كيف نكون شركاء في برنامج وطني للإنقاذ
 كيف نكون شركاء في برنامج وطني للإنقاذ
كيف نكون شركاء في برنامج وطني للإنقاذ
تمثل الحقبة الحالية من تاريخ البلاد ظرفا غامضا وعسيرا ومثيرا للجدل إذ إنها حقبة تواجه فيها تونس تحديات منها الداخلي ومنها الخارجي. أما المناسبة فهي استهلاك السلطة المنتخبة للشرعية السياسية والتي مدتها سنة واحدة تنتهي في الـ23 من أكتوبر الجاري والتي تتطلب رسم توافقات حول التداول الديمقراطي على السلطة نظرا لأنّ السلطة الحالية لم تكن قادرة على رسم خارطة طريق واضحة بخصوص المراحل القادمة. وفي هذا الظرف بالذات، وفي كل الظروف المماثلة التي تستبطن بذور الشقاق والفرقة والانقسام والتأزم، لا نملك إلا أن نساهم بفكرة تندرج ضم برنامج لتقويم السلوك الحضاري.
في هذا السياق نرى أنّ الأفراد والجماعات التي لا تملك المهارات الثورية اللازمة لرفع التحديات من الأجدى أن يتوقفوا عن الحديث عن الثورة وعن الثوار، وعن التلظي غضبا على الحكام وعلى المسؤولين من دون الإسهام في تقديم البدائل الفكرية والسياسية. كما ندعو القيادات السياسية والسلطة الحاكمة للتخلي عن الاستخفاف بالشعب وبرغبته في التحرر، وبإرادته للتقدم، وبثقافته الجديرة بأن يتخذ منها نبراسا ابتغاء التحرك الفعلي في المجتمع، وبتاريخه الحضاري الجدير بدفعه إلى الأمام على درب الإنجاز. ولا يسعنا أيضا إلا أن نلح على الجميع بالنأي بأنفسهم قدر الإمكان عن اعتبار الإسلام اصطلاحا أو عجلة خامسة أو جهازا محمولا أو سلعة تُهرَّب، و في المقابل بمحاولة التحلي بروح الدين الحنيف للتدبر. ولكل الأطراف والفاعلين المعنيين نقول إنّ الوفاق السياسي يتطلب مهارات دون أخرى، ودُربة خصوصية، و مرتكزات علمية. وفي ما يلي جملة من العناصر نقدمها نسوقها في شكل أصناف من الإيمان، علنا نساهم في برنامج عام للإنقاذ الوطني.
أولا: الإيمان أنّ "مثلما تكونوا يولَّى عليكم" كما ثبت لدينا كنتيجة لاستقراء الحديث الشريف.
ثانيا: الإيمان أننا "نكون" طبق سُنن نتحمل نحن كبشر مسؤولية استقراءها، وأننا كتونسيين مَثلنا مَثل البشرية كلها مهما كانت ديانتها وثقافتها وحضارتها.
ثالثا: الإيمان أنّ فساد الواقع بكل تلويناته، الإيديولوجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، لا يعني أنّ من الضروري الانغماس فيه وإلا سنتهم بالمثالية وبالطوباوية.
رابعا: الإيمان أنّنا قابعون في الواقع الفاسد بدعوى الواقعية والإذعان لأحكام الواقع، بينما ما نجنِيه من هذه الوضعية الخاطئة المبنية على إيمان خاطئ هو إعادة تكرير الواقع الفاسد نفسه. وفي هذا السياق لا ينبغي ان نتعجب من محاولة السلطة الحاكمة الحالية العودة بنا إلى الاستبداد. فالنظام الاستبدادي وغيره من الأنساق و القيم السيئة والمنافية للحياة الكريمة لا تسقط بمجرد نعتها بأبشع النعوت. فمنهج الشجب والاستنكار والتنديد والاتهام، لمّا لا يُردَفُ بالمنهج البنائي، خاطئ لأنه يستهلك الوقت الذي كان ضروريا لنسج التصورات و لبناء البدائل.
خامسا: الإيمان بالقدرة الذاتية على تغيير الواقع وبأنّ كلنا أفرادا ومجموعات ومجتمعا نمثل موارد لا تنضب لتموين التصورات الضرورية لمستقبل أفضل، مما يكون ضمانة لتوفر صورة استباقية لواقع أفضل يقدم نفسه على أنه المستقبل. ولا يكتمل رسم هذه الصورة من دون عناء وعمل وابتكار. ولا يكفي أن تنكب الأحزاب السياسية على إعداد برامج للإصلاح والتنمية. فإعداد البرامج يتطلب إعداد المجتمع النشيط والفاعل أي القادر على الإسهام في تصور البرامج. وهذا غير متوفر في تونس اليوم.
سادسا: الإيمان بأنّ الأحكام الإلهية إنما هي علامات دالة على الطريق المستقيم نتفاعل معها لنكيف أفكارنا وسلوكنا نحو الأفضل، فضلا عن كونها خطوطا حمراء تمثل أقصى ما يمكن إن يحدث، إن خيرا أم شرا. وبالتالي الإيمان بأنّ هاته الحرية التي يمنحها لنا الدين الحنيف محررة للإرادة أولا، ومن ثمة للقدرة على التصور بصفته صنفا عظيما من التدبر، ثم للحركة. والحركة لا تؤدي إلى الفعل إلا لمّا يتوفر التدريب المدرسي والاجتماعي والسياسي على البرنامج كله. بينما العقلية الدينية التواكلية هي السائدة الآن في المجتمع، مما أثر وما زال يؤثر سلبا في موقف الفرد والمجتمع من السياسة ومن العمل السياسي وذلك باتجاه حرمانه من تسخير طاقاته كاملة، أي بما فيها الطاقة الدينية، للعمل السياسي، ومما خندق الطاقة الدينية في حزب او أحزاب دينية تكون بهذا المعنى أعراضا لمشكلة أكثر منها بدائل سياسية عما يسمى بالعلمانية. حيث إنه حتى إن اعترفنا بوجود عقلية تقدمية في عديد الأوساط ولدى عديد الفئات المجتمعية فإنّ تلك العقلية نشأت تقدميتُها على مرتكزات معادية لفكرة أنّ الدين عاملٌ للحركة وللتطور وللارتقاء، وهي وضعية تُنسب خطأ إلى العلمانية بينما هي مؤشر على تزييف للإسلام وللعلمانية على حدِّ سواء. إذن فالمسألة الدينية في تونس ليست مشكلة دينية ولا إيمانية ولا إيديولوجية ولا سياسية بقدر ما هي منهجية.
سابعا: الإيمان بأن الناشئة في بلدنا، إن في علاقتهم مع العائلة أم في المدرسة أم في الجامعة أم في المجتمع، لا يدرون كيف يتواصلون لا مع السلطة ولا مع الأحزاب ولا مع الإعلام ، لذا فإنهم يبقون محرومين من ممارسة حقهم وواجبهم في إيصال مشاعرهم وآرائهم وأفكارهم التي تُشكل تصوراتهم التي يرغبون في تحويلها إلى أفعال ينسجون بواسطتها الواقع الجديد، المستقبل. وهذا الحرمان هو للأسف المحرك الأساس للفوضى السياسية التي نشهدها الآن في بلد قوام سكانه جمهورُ الشباب. وهي المادة التي يغتذي منها الاستبداد ويهدد بعودة قوية تكمُن قوّتُها في كَونها مدعَّمة موضوعيا. فهل القادم أفضل؟
محمد الحمّار
رسالة 23 أكتوبر ناقص2 -"الإيمانت" السبعة
 رسالة 23 أكتوبر ناقص 2 - "الإيمانات" السبعة
رسالة 23 أكتوبر ناقص 2 - "الإيمانات" السبعة
في هذا الظرف المثير للجدل والغامض، والعسير والجميل في آن، والمزعج والمطَمئِن في آن، لا نملك إلا أن نتوجه إلى شعبنا الأبي برسالة. نرى أنّ من لا يملك المهارات التالية من الأجدى أن يتوقف عن الحديث عن الثورة وعن الثوار، وعن التلظي غضبا على الحكام وعلى المسؤولين، أو عن الاستخفاف بالشعب وبثقافة الشعب، وكذلك عن اعتبار الإسلام اصطلاحا أو :عجلة خامسة أو جهازا محمولا
واحد: الإيمان أنّ مثلما نكون يولى علينا
.اثنان: الإيمان أننا "نكون" طبق سُنن نتحمل نحن كبشر مسؤولية استقراءها
.ثلاثة: لإيمان أنّ فساد الواقع لا يعني أنه من الضروري الانغماس فيه
أربعة: لإيمان أنّنا قابعون في الواقع الفساد بدعوى الواقعية والإذعان لأحكام الواقع، بينما نحن ما نجنِيه من هذه الوضعية الخاطئة المبنية على إيمان خاطئ هو إعادة تكرير الواقع الفاسد.
خمسة: الإيمان بالقدرة الذاتية على تغيير الواقع وذلك بفضل توفر صورة استباقية لواقع أفضل يقدم نفسه على أنه المستقبل. ويكتمل رسم هذه الصورة بعد عناء وعمل وابتكار.
ستة: الإيمان بأنّ الأحكام الإلهية إنما هي علامات دالة على الطريق المستقيم نتفاعل معها لنتكيف أفكارنا وسلوكنا نحو الأفضل، فضلا عن كونها خطوطا حمراء تمثل أقصى ما يمكن إن يحدث، إن خيرا أم شرا. وبالتالي الإيمان بأنّ هاته الحرية التي يمنحها لنا الدين الحنيف محررة للإرادة أولا، ومن ثمة للقدرة على التصور بصفته صنف عظيم من التدبر، ثم للحركة. والحركة لا تؤدي إلى الفعل إلا لمّا يتوفر التدريب المدرسي والاجتماعي والسياسي على البرنامج كله.
سبعة: الإيمان بأن الناشئة في بلدنا، إن في علاقتهم مع العائلة أم في المدرسة أم في الجامعة أم في المجتمع، لا يدرون كيف يتواصلون مع السلطة حتى يمارسوا حقهم وواجبهم في إيصال مشاعرهم وآرائهم وأفكارهم التي تُشكل تصوراتهم التي يرغبون في تحويلها إلى أفعال ينسجون بواسطتها الواقع الجديد، المستقبل.
محمد الحمّار
تطاوين أمامكم فراجعوا مرجعياتكم
تطاوين أمامكم فراجعوا مرجعياتكم
مرة أخرى تمدنا الأحداث بالدليل على استشراء الإقصاء في المجتمع عموما وفي الحياة السياسية على الأخص. فمقتل المسؤول الجهوي في الفلاحة والصيد البحري والناشط في حزب "نداء تونس" بتطاوبن يدل على هشاشة العقيدة السياسية المشتركة بين التونسيين كافة بصرف النظر على الانتماء الخصوصي إلى حزب سياسي دون آخر. وبالتالي فالوفاق الذي تأمل تونس في الشروع في تحقيقه قبل موعد 23 أكتوبر لا يكفيه الحوار من الصنف السياسي. فالتوافقات المطلوب بلوغها ترتطم بعائق أساس يبرز جليا في التجاذب بين رموز ثقافية عدة كل واحد منها يمارس الإقصاء تجاه البقية: حساسية إسلامية مفرطة تزعم تمثيل الإسلام، فرنكوفونية موالية للقوة الاستعمارية القديمة، يسار كان بالأمس القريب مشتتا لكنه بالرغم من أنه بدأ يلملم جراحه إلا أنه يبقى بحاجة لمشروعية مشتركة؛ هي وغيرها حساسيات تتنابز بالرموز والحال أنّ من الممكن تصحيح العقيدة السياسية بغية توحيدها، وإلاّ فكل حوارٍ يهدف إلى بلوغ توافقات سياسية إنما هو كمَثل دارٍ بلا قواعد، أو كمثل حُكم النظام المخلوع الذي قضى بأن يعيش شعب تونس 23 سنة في ظل الديكتاتورية النوفمبرية المقيتة.
ولكي تُصحَّحُ العقيدة السياسية يتوجب أولا تعريف الوفاق من هذا المنظور التصحيحي ثم النظر في طريقة التصحيح. إنّ الوفاق يترجَم بالتوصل إلى تأسيس الحد الأدنى الممكن من التوحد الإيديولوجي كأرضية سانحة للاختلاف السياسي و للتعددية السياسية. فضمان التوحد الأدنى سينجر عنه تحرر المخيال السياسي حتى يصبح قادرا على حسن التصرف في الاختلاف وفي التعددية وعلى رعايتهما و الحفاظ عليهما . أما المبرر المنهجي الأساس لفكرة التوحيد والتحرير لا يوجد بصفة مباشرة في السياسة أو في الفكر السياسي وإنما في الواقع اللغوي وفي الواقع الديني للمجتمع. وهذا الواقع ذو البُعدين غير مطمئن بالمرة. فاللغة هي محمل الفكر والإيديولوجيا والسياسة، والدين بما يوفره من إيمان حي في الفرد والمجتمع هو المنهاج الذي من المفترض أن تستخدمه اللغة لكي تصل العقل المنتج لتلكم المحمولات بالواقع المعيش. لكن اللغة و الدين الآن بعيدان كل البُعد عن أن يقوما بهذا الدور التشاركي. لذا فبتصحيحهما ستتحد الأرضية ويتحرر المخيال السياسي أي تُصحَّحُ العقيدة السياسية وتصح.
لكن البلاد التونسية بحاجة لحلول عملية عاجلة ومستعجلة. فهل سنشرع في الإصلاح الديني واللغوي ونضحي بالخلاص الآني؟ أم سنسكت عن تمادي الطبقة السياسية في ممارسة التجاذب والفرز الذين يتسبب فيهما الرضاء بعقيدة سياسية بالية ومتكلسة؟ لا هذا ولا ذاك سيشكل مخرجا من أزمة محتملة تحوم حول تاريخ 23 أكتوبر. لذا نقترح في ما يلي عرضا لتوليفٍ استباقي لِما يمكن أن يؤول إليه الوضع الإيديولوجي لو تم إنجاز الإصلاح في مستوى التوظيف الصحيح للغة وللدين. وهي صيغة توليفية من بين صيغ أخرى تتكون من مواقف وآراء وانتقادات ومراجعات وتصورات سياسية وسلوكيات تخص العديد من القضايا لا يسمح لنا حيّز هذه الورقة بالتوسع فيها أو حتى عرضها.
سوف نطرح هذه التجليات في شكل خطاب استباقي مباشر إلى مختلف الحساسيات وهي في وضعية قبلية للتوحّد، لنرى إمكانية تحوّل هذه الأخيرة نحو الأفضل بحسب المنهجية التي وصفناها وبالاستناد إلى قناعات حقيقية. ويكون الطرح كما يلي:
إلى العروببين وإلى الفرنكوفونيين:
ما من شك في أّنّنا معشر التونسيين عربٌ معتزّون بانتمائنا إلى الثقافة العربية الإسلامية. وفي اعتقادنا لم يعُد من مصلحتنا أن نقسّم أنفسنا كما نفعل بين الحقبة التاريخية والأخرى إلى مستعربين أو مُعرَّبين أو عروبيين أو عُرْب أو عُربان أو حتى "أعراب" . وما من شك أيضا في أنّ الكثيرين منا يتقنون اللغة الفرنسية، مما يجعلنا نعتز أيضا بالتراث الثقافي الذي جلبته لنا هذه اللغة ورسخته فينا، مما جعلنا نؤمن بتواصل التلاقح مع الثقافة الفرنسية في أشكالها المعاصرة. وقد يجد بعضنا ضالته الفكرية تارة في أدبيات الجاحظ أو المعري أو نجيب محفوظ أو علي الدوعاجي وغيرهم وطورا في كتابات جون جاك روسو أو ألبير كامي وغيرهما. فاللغة الفرنسية وثقافتها يشكلان عامل تقوية وتوسيع يساهم في تشكيل الهوية الكبرى وبالتالي عامل تمكين للشخصية الوطنية والكبرى، لا عائقا أمام ذلك. كما نحن عرب يتقنون سائر اللغات الأجنبية وفي مقدمتها اللغة الانقليزية، مما يحثنا على مزيد التمكن من هذه اللغات وغيرها ابتغاء تطوير مستوى التعامل مع الناطقين بها. في ضوء هذا نعتقد أنه لا يجوز أن نعرّف عروبتنا بواسطة إقصاء الفكر و الثقافة الوافدتين علينا بطريقة أو بأخرى. بل نميل إلى تعريف العروبة بأنها الاضطلاع بكل الثقافات التي تداخلت مع ثقافتنا الأصيلة النسبية واعتبارها جزءً لا يتجزّأ من العروبة الجديدة. أما إذا أردنا إثبات ذلك بالعمل الملموس لا بالقول فقط فالطريق إلى ذلك هي تحويل الحداثة والمحصول الثقافي الذي نشترك فيه مع الآخر الذي ليس عربيا إلى اللغة العربية. عندئذ سنكف عن طرح مسألة التعريب كمشكلة عصية، إذ إننا نكون قد أنشأنا عقلا لغويا ناطقا بالعربية لكنه متضمنا لفكر عالمي من حيث ثراءه الثقافي وأداءه الحداثي. فالمهم أن نكون قادرين على التعبير عن نفس الوطنية وعن نفس الانتماء وعن التراث المشترك وعن التاريخ المشترك بلغة مشتركة ألا وهي العربية، ولكن أيضا بكل لغة.
إلى العلمانيين والإسلاميين:
"لا إسلامي ولا علماني". هذا هو الشعار الذي اشتغلنا عليه منذ أن تفطنا إلى أنّ كلا الطرفين في المعادلة يمثل لب مشكلة الفرز والاستقطاب. كما أن "الوسطية التأليفية" شعار آخر من الممكن الاستفادة منه بناءً على أنّ الترويج الشعبي وحتى الأدبي لمفردة "الوسطية" عادة ما يتوخى التبسيط السالب أي الذي يُفقد هذا المفهوم الديني/المدني في نفس الوقت معناه وقيمته، بينما الوسطية كما تبيّن لنا إنما هي مسارٌ لا مقالٌ. على أية حال ليس هنالك شعار واحد أو جانب واحد بقادر على تغطية العلاقة المتشعبة بين الدين من جهة وبين كل من الدولة والسياسة والمجتمع من جهة أخرى. ولكي يكون الحسم في هاته المسالة رياضيا، بالمعنَيَين الذهني والحركي، يؤول الأمر إلى طبيعة القراءة المعاصرة للدين الحنيف التي سيتبناها المجتمع. ولئن تبقى هذه القراءة من مشمولات المجموعة العلمية والثقافية وحتى الشعبية فإنّ ما نحن بصدد اقتراحه من أفكار مبادىء ترتكز على قراءتنا للإسلام، التي بدورها ترتكز على منهاج عام صالح لتوليد قراءات متجددة للإسلام سميناه "التناظر والتطابق بين الدين واللغة".
إلى اليساريين والعلمانيين التقدميين وإلى الإسلاميين والليبراليين المحافظين:
من الناحية العلمية والمبدئية لا نبالغ إذا أقررنا بأن ليس هنالك فرق بين أن يكون المرء يساريا أو إسلاميا ولا بين أن يكون المرء ليبراليا أو إسلاميا. وانطلاقا من مسلمة مفادها أنّ الإسلام دين علم لا يسعنا إلا الانحياز للعلم مع الاستئناس بالواقع الثقافي والاجتماعي والسياسي الذي ساد على امتداد قرون والذي ذهب بمجتمع مثل مجتمعنا إلى مثل هذه الانقسامات بين علماني وإسلامي من جهة وبين إسلامي ويساري من جهة أخرى من بين انقسامات أخرى. ومَن يُبجل العلم سيكون قادرا على التثبت من حقيقة لا غبار عليها: لمّا نقوم بنمذجة سلوكياتٍ إسلامية على قاعدة الإسلام المصدري لكن بمقاييس الفكر السياسي المعاصر المرتكز على العلم وعلى قراءة تاريخية للإسلام ولحياة المسلمين سوف ننتهي إلى إثبات أنّ الدين الإسلامي ذو توجه يساري لا ذو توجه يميني كما يشاع ويُروّج له خطأ منذ أن ظهرت مفاهيم اليمين واليسار والوسط في الفكر السياسي الفرنسي إبان الثورة الفرنسية في 1789. وفي ضوء هذا فالمطلوب من الإسلاميين والليبراليين أن يُعلمنوا (نسبة إلى العلم) نظرتهم إلى الإسلام حتى يقتربوا ما أمكنهم من المقصد اليساري الضمني في الإسلام. وحريٌّ أيضا باليساريين أن يراجعوا مرتكزات الهوية لديهم ليتفطنوا أن ليس هنالك مانعٌ في أن يُشكلوا اليسار المؤمن. فليس كل دين يأتي على اليمين في السياسة، والمداومة على تصنيف دين العلم على اليمين في السياسة مرادفٌ لتبويب العلم نفسه على اليمين. وإلا فهل يحق أن نعتبر العلم والعلماء يمينيين لا تُرجَى منهم ولا من أعمالهم ولا من بحوثهم رحمة للفقراء والمساكين والمستضعفين؟
إلى القوميين العروبيين وإلى الإسلاميين:
أنتم الطرَفان اللذان يُجسمان المشكلة الهوياتية أكثر من سائر الأزواج. وأنتم الذين بيدهم الحل والربط بخصوص فك الاحتقان في ما بين سائر الثنائيات حتى نحقق الهوية الكبرى. والسبب في ذلك بسيط: "أنتم مع أنتم" تساوُون "نحن". كلانا عربي ولو لم يتكلم العربية وكلانا مسلم ولو لم يكن مؤمنا. فمن منا ليس قوميا ومن منا ليس إسلاميا إذن؟
إنّ الإسلام دين الفرد ودين المجتمع. والمجتمع هو مجال عمل الدين ومجال فعله ومجال تفاعل الأفراد والجماعات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية معه. أما الدولة فهي الحارس الأمين على الإسلام وبالتالي ليست مجالا تحدُث فيه مباشرة الحركة الإسلامية بمختلف تلوناتها. إذا انطلقنا من هذا المبدأ فسنلاحظ أنّ هنالك تعارضا بين هذا المبدأ وبين وجود الحساسية الإسلامية الحركية السياسية في بلد مسلم مثل بلدنا. وبالرغم من أنه لزامٌ علينا قبول هذا الأمر الواقع ومسايرته، إلا أننا لا نتوانى عن إطلاق نداءٍ مُلحٍّ إلى كل النخب الفكرية وإلى القيادات السياسية مجتمعة، لا إلى الحساسيات الإسلامية فحسب، لتعديل دور الإسلام في الحياة العامة وما سينجرّ عنه من ترشيد للتديّن وذلك وِفق تلك القاعدة، قاعدة ما للدولة للدولة وما للمجتمع للمجتمع. فبهذا التعديل سيستردّ الشعب الإحساس بالاضطلاع بهويته القومية الطبيعية والتي كان مسلوبٌ من قسطٍ كبير منها بحُكم استحواذ الحساسية الإسلامية السياسية على ذلك القسط. وبهذا التعديل سيستردّ الشعب أيضا هويته الإسلامية الطبيعية والتي كان مسلوبٌ من قسطٍ كبير منها بحُكم استحواذ الحساسية القومية على هذا القسط. ومن هنا يصير الإسلام افتراضيا ومبدئيا للجميع وتصير القومية افتراضيا ومبدئيا للجميع بعد أن يكون كلاهما قد تحرر من التجاذب إزاء الآخر. فيكون حينئذ الانصهار بين القومية والإسلامية.
ومن هنا ننتقل إلى الدور الذي ستلعبه اللغة العربية في المجتمع المسلم. فمن جهة، مثلما صار الإسلام افتراضيا ومبدئيا للجميع، لم يعُد هنالك مانعٌ في أن تقتفي اللغة العربية، وهي بامتياز لغة القومية، لأثر هذه الأخيرة فتصير على غرارها هي الأخرى ملكا للجميع. ومن جهة أخرى، لمّا نعلم أنّ العقل اللغوي للناطقين باللغة العربية في المجتمع قد امتصّ اللغة والثقافة الفرنسيتين فضلا عن استيعابه لكل وافدٍ من الثقافات واللغات الأخرى التي انفتح عليها المجتمع وتعامل معها العقل اللغوي، سنتأكد من أنّ توسّع اللغة للعربية قد بلغ مستويات عالية جدا. وخلاصة القول أنّ "العربية للجميع" ستعني أنّ المسلم عربيٌّ وانّ العربيّ مسلمٌ وأنّ من كان يسمى فرونكوفونيا أضحى عربيًّا متفتّحًا وأنّ العربيّ هو من ينطق بالعربية كلغة أمّ ومَن ينطق باللغات الأخرى مع بقائه عربيّا.
إلى المتفتحين المتأصلين وإلى المنفتحين المغتربين وإلى المنغلقين المنطوين على ذواتهم:
إن التعامل بندية مع الأمم المتقدمة ابتغاء شذب التبعية هو المحور الرئيسي في الحديث إليكم. والندية المنشودة تضعكم أمام تحدٍّ حضاري لبلدان قد منحَها تقدمُها مبررا للهيمنة على بلدان مازالت تبحث عن نفسها مثل تونس والوطن العربي بأكمله. أما الأحقية في تحقيق الندية فلهُ مبرراته في الثورة وفي أهداف الثورة وفي الرغبة في تحقيقها. ومن أخطر الجوانب التي ترتسم فيها ينبغيات الندية ومستلزماتها نذكر جانبَ الرسالة التي ستتضمنها اللغة العربية بصفتها لا فقط أداةً يتوجب تطويرها والارتقاء بها إلى مستوى اللغات التي تنطق بها تلك الأمم وإنما أيضا بصفتها فكرًا، أي فكرا منبثقا عن الثورة وعن التفكير الثوري بالتحديد. فاللغة، لمّا تؤدي وظيفتها كفكرٍ للثورة (وتثبت كمفصل للهوية الكبرى)، تتحول بكل جدارة إلى مضمون للسياسة الكبرى التي نطمح إليها.
كما يستبطن هذا الجانب المقاصدي للغة عديد الجوانب الأخرى التحتية أو الساندة لغاية السموّ باللغة العربية وبالناطقين بها إلى مكانة الهوية الكبرى المؤدية للسياسة الكبرى. وأبرز هذه الحوافز الغيرةُ التي ينبغي أن تتوفر عند الشباب الحالي؛ غيرة من المكانة المرموقة التي تحظى بها لغات الأمم الراقية على غرار اللغة الانقليزية واللغة الألمانية. وهي غيرة وظيفية لا انفعالية تندرج في إطار تحفيز الأجيال الجديدة على صنف من الانقلاب في الموقف إزاء اللغة. ويتمثل الانقلاب في استبدال محاكاة الشباب للغرب والتي للأسف تتم إلى حد الآن بواسطة التصاقهم المرَضي بلغات هذا الغرب، استبدالها بمحاكاة نفس هذا الغرب في اعتزازه بلغاته وبحرص أهله على صيانة اللغة الأم وترويجها بين الأمم.
الخاتمة
في الختام نعوّل على الطبقة السياسية كافة وعلى كل الفاعلين في المجتمع المدني ليجسدوا مثل هذه الوضعية الاستباقية الوفاقية في المستقبل القريب. وهو مطلب ليس بعزيز عليهم بدليل أنهم حريصون على العمل الدءوب من أجل أن تتجنب تونس أزمة حقيقية بسبب اقتراب موعد 23 أكتوبر. وحتى وإن تعذر ذلك فالأهم هو الإيمان بأنّ التغيير نحو الأفضل أضحى خيارا حقيقيا للتونسيين كافة. وكما أثبته العلم الحديث وآثاره على الفلسفة (نظرية "سهم الزمان" لإيليا بريغوجين) فإنّ الإيمان بصورةٍ معينة للمستقبل هو الذي يكيّف الحركة في الزمن الحاضر. وهل تونس وشعب تونس بحاجة لأقل من الحركة المُبدلة للواقع نحو تحقيق أهداف الثورة وصياغة البديل المحلي والعالمي ؟
عاشت تونس في مأمن من كل المكائد وفي غنًى عن الأزمات. عاشت تونس رائدة في مجال غزل المستقبل الأفضل لشعبها و للإنسانية.
محمد الحمّار
فيديو الغنوشي أو التكيّف مع الإرادة الأمريكية
فيديو الغنوشي أو التكيّف مع الإرادة الأمريكية
يعلم القاصي والداني أنه تم مؤخرا تسريب فيديو لراشد الغنوشي في حديث سري مع السلفيين. وقد أقام الشريط الدنيا ولم يقعدها بعدُ نظرا لكشفه عن تواطؤ رئيس حزب حركة النهضة مع الطيف السلفي بخصوص مسائل تتناقض مع النمط المجتمعي التقدمي الذي دأبت عليه تونس على امتداد عقود. ومهما يكن من أمر نعتقد أنّ الأهم ليس الحسم بخصوص وجود تواطؤ بين اللونَين الإسلاميين من عدمه (فذلك بات يقينا حتى قبل تسريب الفيديو الحدث مؤخرا)، بل الأهم أن نستخلص العبرة من حدث التسريب نفسه وذلك من خلال محاولة نبيّن من خلالها أنّ منهجية التسريب قد تكون أخطر من مضمون الفيديو المسرب، ونأمل أن نعثر في طياتها على رسم معيّن أو سياسة معينة يشترك فيها الطيفان الإسلاميان، المجتمِعان في مكتب رئيس حركة النهضة، أو تشترك فيها طرف منهما مع طرف خارجي.
لهذا الغرض نبدأ بالتذكير بأنّه قد قيل إنّ الشريط المعني متوفرٌ على المواقع الاجتماعية منذ الربيع الماضي إجمالا. وفي هاته الحالة يحق التساؤل: لماذا أثار الشريط استنكارا وتنديدا غير مسبوقين الآن ولم يثر أية ردة فعل تذكر إبان نشره للمرة الأولى؟ بكلام آخر ما الذي حدث في الأثناء؟ وسواء صحت هذه الفرضية أم لم تصح، نجيب بالقول إنّ ما حصل في الأثناء له علاقة لا فقط بتواطؤ اللونين الإسلاميين مع بعضهما البعض وإنما أيضا بسياسة الولايات المتحدة في تونس وفي المنطقة عموما. فـ"غزوة السفارة" (14-9-2012) جاءت كالصاعقة لترج الكثير من الوضعيات ولتضفي معنى جديدا على الأحداث وعلى مضمون الفيديو المسرب بالذات. و"الغزوة" المتمثلة في هجوم نفذه جمعٌ من السلفيين على مقر البعثة الدبلوماسية للقوة الأعظم في العالم تمّ على مرأى ومسمع من قوات الأمن، كانت عاملا مرشحا للتداخل مع عامل التسريب. بالتالي و من خلال قراءة سنكرونية وبَعدية للحدثين ("الغزوة" والتسريب)، أضحى الشريط يكتسب عنصرا لم يكن يكتسبه من قبل: فضحُ الفاعلِ والساكتِ عن الفعل معا؛ السلفيين وحزب حركة النهضة. لكن لو توقف الأمر عند هذا الحدّ لبقيت المشكلة مسألة داخلية لا تهم إلا التونسيين. لكن حادثة السفارة ارتقت بالمشكلة إلى البوتقة الخارجية، دبلوماسيا وسياسيا، كنتيجة لتقاطعها مع التسريب ومع مضمون المادة المسربة. وكانت النتيجة أن وجدت كل من السلفية وحزب النهضة نفسهما مُجبرتَين على سلك الطريقٍ المسطرة من طرف الولايات المتحدة منذ سنة 2003 والتي تتوعد بمقاومة الإرهاب وبإرساء ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد. لنرَ كيف حصل ذلك على الساحتين الداخلية والدبلوماسية.
على الساحة الداخلية، استنفذ كل من السلفيين وحزب النهضة لكل المبررات المشتركة لسياسة التكتم على ضلوعهما في نفس المشروع الملتحي. وأصبح ذلك يعني أنه لم يعد للطرفين أي مبرر لحجب التزاوج بينهما. وسواء تسريب الشريط أخذ حزب النهضة على حين غرة، أم كان هذا الأخير هو المُسرب، فالنتيجة هي نفسها: لقد مكنت "الغزوة" حزب النهضة من التحرر من عقدة التكتم ، كما مكنت السلفيين من التحرر من عقدة أمريكا. وبالتالي لا "النهضة" ما زال يهمها أن يدرك الرأي العام تواطؤها مع السلفية و لا السلفية مازال يهمها النأي بنفسها عن التحرك سرا وعن استهداف الولايات في تحركاتها. كما أنّ الذي بات يهم حزب النهضة، وبصفة مُلحة وأكثر من أي وقت مضى، هو اصطياد عصفورين بحجر واحد: أولا، إرضاء السلفيين، مما يستلزم الكشف عن التزاوج الذي كان مخفيا وإبرازه للعيان، إن تملقًا و تزلفًا أم تجاهرًا. وهذا يصح في حال صحة الفرضية القائلة بتعمد تسريب الفيديو من طرف النهضة تحديدا أو السلفيين تحديدا أو الاثنين معا، أو حتى في حال وقوع التسريب على حين غرة. فلا يهم من قام بالتسريب. ثانيا، إرضاء الولايات المتحدة نظرا للإهانة التي تعرضت إليها ونظرا لأن حكومة الترويكا النهضوية كانت مسؤولة عن انخرام الأمن حول مبنى السفارة الأمريكية. مع العلم أنّ هذه الرغبة تتباين مع الأولى حيث إنّ الذي بات يهم السلفيين هو المضيّ قُدُما في إهانة الدولة الأقوى في العالم.
في نفس السياق لكن على الجبهة الدبلوماسية، نلاحظ أنّ الموقف الأمريكي قد تبدّل مرتين، مرة إزاء حزب النهضة لمّا تبينت أمريكا أنه لم يعد ذلك الصديق الذي لا يتوانى عن الذود عنها في حال هوجمت من قِبل أطراف محلية، و مرة إزاء السلفيين لمّا صُدمت بمدى الحقد الذي يحملونه إزاءها. ومن خلال كلتا الحالتين يتأكد لدينا أنّ تبدّل معنى الفيديو اليوم، عما كان يعنيه في أي وقت آخر (قد يكون نشر فيه كما يزعم بعضهم)، وحتى عما تعنيه المادة بحد ذاتها، يكمن في تبدّل الموقف الأمريكي من الطرفين المجتمعين في الشريط المسرب أكثر من أن يتمثل في كشف النقاب عن التعاون بين الطيفين الإسلاميين أومحاولة أحد الطرفين إرضاء الآخر. وما دام الأمر كذلك يحق افتراض وجود مصلحة أمريكية من وراء تسريب الشريط . من هذا المنظور فما آل إليه المنهج التسريبي، البَعدي للحادث الديبلوماسي، من المفروض أن يدعو الرأي العام إلى التأمل الشديد فضلا عن لزوم الحذر الشديد بعد انكشاف نية السلفية بشقيها النهضوي والجهادي في إرساء الدولة الدينية وإقامة الشريعة. وها أنّ تأكيد الفرضية يأتينا من عند السفير الأمريكي نفسه، جاكوب والس، بضعة أيام بعد يوم التسريب (التسريب تم في يوم 9-10- 2012 وتصريح السفير في يوم 13 من نفس الشهر). يقول السفير:"أدعو الحكومة التونسية إلى إنجاز تحقيقاتها وتقديم الجناة ومدبري هذا الهجوم إلى العدالة". إلا أنّ السفير، بعد الإفصاح عن هذا الطلب المنطقي و المعقول، يضيف: "وأتطلع أيضا إلى أن يتحدث الشعب التونسي علنا عن العنف والإرهاب ويقوم بدور فعال في صياغة المستقبل الذي يستحقه بجدارة" (عن جريدة "المغرب"، بتاريخ 14-10-2012، ص3). فلئن يتعين على الشعب التونسي الاستجابة لطلب الأمريكان بعقاب المتطاولين على رمز سيادة بلدهم وحماية البعثة الأمريكية مستقبلا، فبأية صفة تقترح الولايات المتحدة على شعب تونس ما يصلح من مواضيع ومتى كانت مسألة "العنف والإرهاب" تقتصر على السلفيين أو النهضويين أو العرب أو المسلمين دون سواهم، أمريكيين كانوا أم غير أمريكيين؟ للإجابة يمكن القول إنّ منهج التسريب، وهو الذي يذكرنا بـ"الويكيليكس"، أزاح الستار عن قابلية كامنة لدى السلطة المؤقتة في تونس للتكيف مع الإرادة الأمريكية (مثلما تكيفت مع إرادة دعاة الشعوذة الدينية المستوردة) وبالتالي لتطويع إرادة الشعب التونسي للرغبة الأمريكية، مما يتنافى مع مبادئ الثورة لأنه يدعم الجانب الإيديولوجي الامبريالي على حساب الجانب السياسي والاجتماعي التحرري الوطني الذي يفرضه التاريخ وتجدد مشروعيتَه الثورة. ولئن كان الأسلوب السلفي أبغض الأساليب عند التونسيين في "صياغة المستقبل" فهل أنّ مقاومة هذا الأسلوب تستوجب إتباع الأسلوب الوصائي الأمريكي، مما يذكرنا بالعقيدة المقيتة "إن لم تكن معنا فأنت ضدنا"؟ وما هي الضمانة لتبرئة السياسات الدولية و الأجنبية بما فيها السياسة الأمريكية من إمكانية التسبب في صعود السلفية وفي انتشار العنف السلفي؟
مهما يكن من أمر، لكأنّ تسريب فيديو الغنوشي أريد به ضمنيا قول ما يلي إلى التونسيين: "نحن حزب النهضة، سواءً اعتقدتم أننا المسربون للشريط أم ألححتم على أنكم أنتم الفاعلون، نعلن أنّ معشر السلفيين منضوون جهرا ابتداءً من الآن تحت لوائنا.ها نحن اعترفنا أمام الملأ بمساندتنا لسياستهم الملتحية وها هي أمريكا مستاءة منا ومنهم في الآن ذاته. فلا يمكنهم نقض هذه الحقيقة طالما أنّ كل الشعب يملك الدليل (الشريط) على أنهم يبحرون على نفس الموجة معنا. وإذا أراد هذا الشعب مقاومتهم فقد أعلن مقاومته لنا في الآن ذاته. ويبقى نهج المقاومة الأسلم أن نقتفي جميعا آثار الأجندة العالمية الأمريكية. فاحذرونا واحذروا الأمريكان يرحمكم الله."
محمد الحمّار
المجتمع السياسي بحاجة لحدّ أدنى من التوحد الإيديولوجي
المجتمع السياسي بحاجة لحدّ أدنى من التوحد الإيديولوجي
في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتي تتسم بالتجاذبات الإيديولوجية بين الفرقاء السياسيين وما انجرّ عنها من انشقاقات وتصدعات في داخل الأحزاب و من إعادة التشكل ضمن تيارات وجبهات جديدة، ومع العلم أنّ الخلافات نتاجٌ لتراكمات عديدة ومتشعبة نشأت على امتداد عقود طويلة إن لم نكن قرون، نتقدم بتصوّر لما أسميناه "الحد الأدنى من التوحد الممكن". وقد سبق أن خصصنا لهذا الموضوع نصا تمهيديا بعنوان "آلية مكملة لمبادرة الاتحاد" (الاتحاد العام التونسي للشغل؛ منشور بجريدة "الشعب" عدد 1185، بتاريخ 30 جوان 2012، ص21). ويرتكز حرصنا على أن يحقق المجتمع السياسي الحد الأدنى الممكن من التوحد ومن ثمة على أن يحوله إلى خطة قابلة للتنفيذ الفوري على مسَلمة نلخصها في ما يلي: إنّ المجتمعات التي صعد فيها الإسلام السياسي إلى سدة الحكم ضِمن ما يسمى بالربيع العربي تعيش في اعتقادنا كارثة وجودية وفلسفية سينبثق عنها أحد خيارين اثنين؛ إما الثورة المتواصلة والنهوض وإما الانقراض الثقافي. و نرجّح الخيار الأول لا لشيء سوى لأننا نعول على تصورات مستحدثة تقطع مع الرتابة والتكرار والإتباع.
إنّ تردي الوضع الإيديولوجي والسياسي والحزبي في تونس يتزامن مع ارتباك السلطة وتلكؤها وتعثرها في التعامل مع الملفات المطروحة والذي يقابله عدم رضاء المعارضات والأحزاب عن الأداء الحكومي. وما من شك في أنّ الفشل السلطوي وعدم الرضاء المقابل له ينبعان من أصل واحد ألا وهو احتقان المخيال السياسي. فالمخيال هو الذي من شأنه أن يزود العقل المجتمعي بالتصورات وبالرؤى التي تتحول في مرحلة تالية إلى توجهات عامة ومرتكزات لسياسات يتم اعتمادها في ما بعد في تأسيس مشاريع و برامج ترضي الناس أجمعين. ولمّا نعلم أن احتقان المخيال السياسي هو بدوره يعود إلى حالة الاحتقان الإيديولوجي والخلط العقائدي، نتخلص إلى التأكيد على أنّ فك الاحتقان رهنٌ بالتوحيد الإيديولوجي وبتوحيد العقيدة السياسية حتى تتشكل لدى الجميع الأرضية اللازمة للوفاق. وهذا التوحيد سيتطلب في مرحلة موالية إعادة تبويب المشكلات والشواغل، ومنه إعادة ترتيب الأولويات السياسية وما سيلحقه من إعادة توزيع للتوجهات السياسية الكبرى، وذلك بعد أن يكون قد تمّ زحزحتها من البوتقة الفضفاضة والهلامية بعنوان الهوية إلى البوتقة الحقيقية الرحبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي المحلي وحتى للواقع الجيوستراتيجي وللواقع الجغرسياسي.
بكلام آخر: لا يمكن لحزب من الأحزاب أن يتوحد في داخله ولا لأن يتوحد مع حزب آخر طالما أنّ هنالك شحّ في الموارد الفكرية الضرورية لتشكلِ التصورات والرؤى. كما لا يمكن للموارد الفكرية أن تتفتق وتينعَ بصفة جماعية فتعود بالفائدة على كل حزب وكل كتلة بما فيها الأحزاب الحاكمة إلاّ في حال يتمتع كل حزب وكل كتلة بحدّ أدنى من التوحد الإيديولوجي، في داخل كل واحد منها وفي ما بين بعضها بعضا. ولا يمكن لهاته الأحزاب أن تصوغ سياسات مرْضية في غياب هذا التوحد الذي من شأنه أن يحرر المخيال السياسي، مما سيسمح بإعادة توزيع التوجهات السياسية، ومنه بتقريب وجهات النظر بين الفرقاء ثم الاتفاق حول المبادئ والأهداف والغايات المشتركة.
فقط بعد استكمال التوحد الأدنى يمكن الحديث عن بلورة الاختلاف، "اختلاف الرحمة"، ضمن تصورات ورؤى ومشاريع وبرامج تميز الأحزاب عن بعضها البعض. ولعل إعادة التشكل الحزبي الذي تشهده الساحة منذ أشهر والذي جاء كنتيجة لعدم رضاء الأحزاب على شكلها المتكلس القديم خير دليل على صحة هذا التمشي. والمطلوب الآن دعمه بواسطة آليات توحيدية.
محمد الحمّار
أيهما أخطر، مضمون الفيديو أم رسالة التسريب؟
أيهما أخطر، مضمون الفيديو أم رسالة التسريب؟
الحدث أو العملية أو السياسة أو الفكرة لا تقاس قيمتها من داخلها وإنما من خلال النتائج المنجرة عنها. هذا تعريف تقريبي للبراغماتية (الذرائعية) وهي فلسفة أمريكية غالبا ما تغالي الأدبيات التونسية و العربية في خلطها مع المنوال التجريبي والميداني والعملي. وهو خلطٌ تبرز خطورته الآن بالذات على إثر تسريب الشريط المتضمن لخطاب راشد الغنوشي أمام جمعٍ من السلفيين. لنرَ المسار الذي قد يبيّن صحة هذا الاستنتاج ولنرَ أين تكمن الخطورة.
لقد شهدت تونس في الماضي القريب و على امتداد أشهر نوعا من الصراع المشبوه بين حزب حركة النهضة وبعض فصائل السلفية. ومهما يكن من أمر فالمهم ليس الحسم في وجود تواطؤ بين اللونَين الإسلاميين من عدمه (فذلك بات يقينا قبل تسريب الفيديو الحدث)، بل الأهم استخلاص العبرة من المحصول الحاصل كنتيجة لاحتكاك الطيفين الاثنين ببعضهما البعض وذلك على محك تسريب الشريط الحدث. في هذا المستوى تبرز قيمة الشريط المسرب والذي شوهد فيه رئيس حركة النهضة يتحدث إلى بعض القادة السلفيين ويتجاذب معهم أطراف حديثٍ مركزُه "الشريعة" من بين محاور هامة أخرى. وفي هذا السياق يمكن اعتبار الشريط محصولا حاصلا لِما آلت إليه العلاقة بين الطيفين الإسلاميين الذي يجمع بينهما الشريط. لكن ما هوالأهم، مضمون الفيديو أم منهجية تسريبه؟
للإجابة نصرّ على أننا لا نعتزم التعرض إلى مضمون الشريط أو تحليله ولا البحث عن مدى تورط راشد الغنوشي في مناصرة المشروع السلفي من عدمه. لو فعلنا ذلك لحكمنا على أنفسنا بتوخي التكرار الممل، طالما أنّ المادة المسرّبة نالت ما يكفي من التحليل والتعليق. لكن عوضا عن ذلك، حريّ بنا أن نتوقف عند التوقيت الذي سُربت فيه المادة ومن ثمة سنحاول استقراء المنهج التسريبي نفسه علَّنا نعثر على رسم معيّن أو سياسة معينة يشترك فيها الفصيلان الإسلاميان، المجتمِعان في مكتب رئيس حركة النهضة، أو تشترك فيها "النهضة" مع طرف آخر.
لهذا الغرض نبدأ بالتذكير بأنّ الشريط المعني متوفرٌ على المواقع الاجتماعية منذ الربيع الماضي إجمالا ثم نتساءل: لماذا أثار الشريط استنكارا وتنديدا غير مسبوقين الآن ولم يثر أية ردة فعل تذكر إبان نشره للمرة الأولى؟ بكلام آخر ما الذي حدث في الأثناء، في الحراك الجامع بين الحساسيتين؟ للإجابة نقول إنّ ما حصل من الناحية الحركية أنّ السلفية قد استكملت استهلاكها تقريبا لكل مبررات وجودها. وكان الختام "مسكا" في "غزوة السفارة" في يوم 14 سبتمبر. أما الدليل على كون الاستهلاك كان نهائيا فهو تنصّل "النهضة" من كل مسؤولية عما حصل وكذلك من كل التزام بحماية قد ينتظرها منها السلفيون، بصفتهم مقترفي الهجوم على السفارة الأمريكية. كما أنّ "الغزوة" في الآن ذاته مكّنت "النهضة" من التحرر من العقدة السلفية إن صح التعبير، أي أنّ رموزها لم يعودوا يشعرون بلزوم التكتم على العنف السلفي. ثم إنّ هذا التحرر هو الذي آل إلى إرادة التحرر أيضا من شيء آخر ألا وهو الرقابة الذاتية التي كانت تكبّل القادة النهضويين بخصوص شكوك الرأي العام في كونهم يتحركون بكل تكامل مع السلفيين. أي أنّ النهضة لم يعد يهمها إن كان الرأي العام يدرك تواطؤها مع السلفية بقدر ما يهمها كثيرا وبصفة مُلحة جذب السلفيين نحو بوتقة مستحدثة، كما سنرى لاحقا. وهذا ما قد يؤيد الفرضية القائلة بتعمد تسريب الفيديو من طرف النهضة تحديدا.
وإذا اتبعنا هذا المنطق سنكتشف أنّ التسريب قد أضفى، أو قد أريد له أن يضفي، معنًى جديدا للشريط المسرب غير ذي المعنى الذي كان ينطوي عليه إبان نشره لأول مرة. والمعنى يتشكل هذه المرة في ضوء المستجدات السياسية وعلى الأخص في حادثة السفارة. فعند إطلاق الفيديو في الربيع الماضي لا أحد كان مهيئا لتقبل كلام الغنوشي الذي توجه به إلى السلفيين على أنه مثيرٌ للغضب كما هو الشأن إبان التسريب الحالي. بل قد يكون خطاب الزعيم النهضوي قوبل آنذاك بمثابة صنيعة أي على أنه مثالٌ في الصدق بما يتضمّنه مِن انسجام في الخطاب الإسلامي الداخلي ومِن حرصٍ مشترك على أسلمة الدولة والمجتمع، ولو كان المتقبل غير راضٍ عن المنظومة بأكملها (فقبول التعرف على التواطؤ لا ينفي رفضه، مع السكوت عنه إلى حين). وبالتالي يتمثل تبديل معنى الفيديو اليوم في تبدّل الموقف الأمريكي من حزب النهضة ومن رموزها. وأصبح المعنى يتضمن هذه المرة تذكيرا مغشوشا بصدق زعيم حركة النهضة وذلك ابتغاء اصطياد عصفورين بحجر واحد: من جهة محاولة (تكتيكية) لتبرئةٌ ذمة النهضويين إزاء السلفيين ومغازلة هؤلاء لأولئك من جديد في ظرف ينذر بالقطيعة بين الطيفين الإسلاميين، ومن جهة أخرى ترسيخٌ غريب لرأي راسخٍ بعدُ لدى خصوم النهضة ولدى الرأي العام، وهو الرأي القائل بسلفية حزب حركة النهضة وتواطئها مع رموز وقيادات السلفية الجهادية، بل وبحرصها المشترك مع السلفيين على تطبيق الشريعة، من بين أشياء أخرى. وهذا المنهج الترسيخي هو الذي من المفروض أن يدعو الرأي العام إلى التأمل والحذر الشديد. فهل حدثَ ارتداد في الرأي العام بخصوص تواطؤ "النهضة" مع السلفية حتى يأتي مَن يُعيد ترسيخه؟ سيما أنّ راشد الغنوشي بنفسه يحرص على اعترافٍ (دعائي) بصحة مضمون الشريط المسرب (تصريحه في نشرة الأنباء في ليلة 11-10-2012 وفي برنامج خاص أعدّ ليلتها بالمناسبة). إنّ الخطر يكمن مبدئيا في طبيعة هذا المنهج التسريبي والمرسِّخ لحقيقة معلومة، وهو بصفته هذه، منهجٌ مكيِّفٌ لإرادة الشعب ومنافٍ لمبادئ الثورة لأنه يدعم الجانب الإيديولوجي على حساب الجانب السياسي والاجتماعي الذي تجسمه الثورة، واستفزازٌ لمناصري النمط المجتمعي التقدمي. فيبقى المنهج بالمحصلة مكرسا لإرادة حزب حركة النهضة دون سواها ولنمط الدولة الدينية دون سواها.
ومن هنا نأتي إلى الخطر الأكبر. فمن أين لحزب النهضة اللجوء إلى مثل هذا المنهج في التعامل مع المعلومة وبواسطتها؟ ومَن الذي قد يكون وراء الرغبة في ترسيخ حقيقة معلومة ضمنيا حتى تصبح ذائعة بكل مباشراتية؟ فحزب النهضة الذي لم يكن قادرا على امتداد الأشهر العشرة التي قضاها في الحكم على تركيع الأهالي في عديد الجهات لمّا أراد فرض المعتمدين والولاة عليهم، من أين له أن يستنبط منهجا للتسريب جديرا بالـ"ويكيليكس"؟ اللهم إلاّ إذا كان الذي فعل الفعلة طرفٌ يعتبر نفسه ضالعا في مجريات الأحداث و معنيا بالنتائج التي قد تفرزها هذه الأحداث، بما فيها حدث التسريب نفسه، مما لا يستبعد الفرضية القائلة بضلوع الطرف الأمريكي، وهو المعني وبدرجة عالية، بالمجريات الأخيرة بالنظر إلى واقعة السفارة وبالنظر إلى الإطار العام للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي صورة عدم صحة هذه الفرضية، قد تصح فرضية استلهام "النهضة" للمنهج من عند الأمريكان وبالتالي تتأكد فرضية تعمد هذا الحزب تسريب الشريط مؤخرا لتأكيد موالاته للسياسة الأمريكية مقابل سكوت القوة العظمى عن مساعي "النهضة" لإقامة دولة دينية ملتحية.
وفي كلتا الحالتين أليس المنهج حمّالا لروح الفلسفة والسلوك الأمريكيين المسمى بالـ"البراغماتية" (الذرائعية)، وأليست "النهضة" شريكا للولايات المتحدة بما يلوّح بالتشارك معها حتى في المناهج وأساليب العمل والتحرك السياسي، بما فيها الذرائعية؟ أليست الرسالة التسريبية تقول ضمنيا: "نحن حزب النهضة وأمريكا نعلن أنكم يا معشر السلفيين منضوون جهرا ابتداءً من الآن تحت لوائنا. فلا يمكنكم نقض هذه الحقيقة طالما أنّ كل الشعب يملك الدليل (الشريط) على أنكم تبحرون على نفس الموجة مع حزب النهضة. فاحذرونا يرحمكم الله."
بكل المقاييس، وبصرف النظر عن صحة مضمون الفيديو من عدمها، من الأرجح أن يكون توقيت التسريب هو التجسيد الوقح للخطر الأكبر. وبالتالي نحن أمام فتيلة موقوتة تكمن خطورتها في ممارسة البراغماتية لا فقط على طيف السلفيين، الذي لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من التونسيين، لكن على الشعب التونسي بأكمله، مجتمعيا وإعلاميا، وبأيادٍ سياسية أهلية. وهو المنهج الخطير الذي طالما احترزنا على استهلاكه بصفة اعتباطية ولاواعية في مجتمعنا (مقالنا "الصراع بين الشريعة والذريعة"، منشور على المواقع الالكترونية). فالمنهج التسريبي ذرائعيّ بامتياز إذ إنه يهدف لا فقط إلى تطبيع التونسيين مع الشريعة كوسيلة للاستبداد بالمجتمع، ومع مَن يريد تطبيقها، ومع مَن يرغب في ممارسة الاستبداد بالشعب، وإنما أيضا، وهو الأدهى والأمرّ، إلى تطبيعهم مع وسيلة خبيثة تزيّنُ لهم الاستبداد "الشرائعي" شريطة أن لا يمسّ هذا الأخير مصالحَ الدولة الأعظم بأيّ سوء.
محمد الحمّار
هل الفيديو المسرب صنيعة أم فتيلة موقوتة؟
 هل الفيديو المسرب صنيعة أم فتيلة موقوتة؟
هل الفيديو المسرب صنيعة أم فتيلة موقوتة؟
شهدت تونس في الماضي القريب و على امتداد أشهر نوعا من الصراع المشبوه بين حزب حركة النهضة وبعض فصائل السلفية. ومهما يكن من أمر فالمهم ليس الحسم في وجود تواطؤ بين اللونَين الإسلاميين من عدمه بل الأهم استخلاص العبرة من أداء كل واحد منهما ومن المحصول من الأداءين الاثنين. وفي هذا المستوى تبرز قيمة الشريط المسرب مؤخرا والذي شوهد فيه رئيس حركة النهضة يتحدث إلى بعض القادة السلفيين ويتجاذب معهم أطراف حديثٍ مركزُه "الشريعة" من بين محاور خطيرة أخرى.
في هذا السياق لا نعتزم التعرض إلى مضمون الشريط أو تحليله ولا البحث عن مدى تورط راشد الغنوشي في مناصرة المشروع السلفي من عدمه. لو فعلنا ذلك لحكمنا على أنفسنا بتوخي التكرار الممل، طالما أنّ المادة المسربة نالت ما يكفي من التحليل والتعليق. لكن عوضا عن ذلك حريّ بنا أن نتوقف عند التوقيت الذي سُربت فيه المادة ومن ثمة سنحاول استقراء المنهاج التسريبي نفسه علَّنا نعثر على رسم معيّن أو سياسة معينة يشترك فيها الفصيلين الإسلاميين، المجتمِعين في مكتب رئيس حركة النهضة، أو تشترك فيها "النهضة" مع طرف آخر.
لهذا الغرض نبدأ بالتذكير بأنّ الشريط المعني متوفرٌ على المواقع الاجتماعية منذ الربيع الماضي إجمالا ثم نتساءل: لماذا أثار الشريط استنكارا وتنديدا غير مسبوقين الآن ولم يثر أية ردة فعل تذكر إبان نشره للمرة الأولى؟ بكلام آخر ما الذي حدث في الأثناء، في الحراك الجامع بين الحساسيتين؟ للإجابة نقول إنّ ما حصل من الناحية الحركية أنّ السلفية قد استكملت استهلاكها تقريبا لكل مبررات وجودها. وكان الختام "مسكا" في "غزوة السفارة" في يوم 14 سبتمبر. أما الدليل على كون الاستهلاك كان نهائيا فهو تنصّل "النهضة" من كل مسؤولية عما حصل وكذلك من كل حماية قد ينتظرها منها السلفيون، بصفتهم مقترفي الهجوم على السفارة الأمريكية. كما أنّ "الغزوة" في الآن ذاته مكنت "النهضة" من التحرر من العقدة السلفية إن صح التعبير، أي أنّ رموزها لم يعودوا يشعرون بلزوم التكتم على العنف السلفي. ثم إنّ هذا التحرر هو الذي آل إلى إرادة التحرر أيضا من شيء آخر ألا وهو الرقابة الذاتية التي كانت تكبل النهضويين بخصوص شكوك الرأي العام في كونهم يتحركون بكل تكامل مع السلفيين. وهذا ما قد يؤيد الفرضية القائلة بتعمد تسريب الفيديو من طرف النهضة تحديدا.
وإذا اتبعنا هذا المنطق سنكتشف أنّ التسريب قد أضفى، أو قد أريد له أن يضفي، معنًى جديدا للشريط المسرب غير ذي المعنى الذي كان ينطوي عليه إبان نشره. والمعنى يتشكل هذه المرة في ضوء المستجدات السياسية وعلى الأخص في حادثة السفارة. فعند إطلاق الفيديو لأول مرة لا أحد كان مهيئا لتقبل كلام الغنوشي الذي توجه به إلى السلفيين على أنه مثيرٌ للغضب كما هو الشأن إبان التسريب الأخير. بل قد يكون خطاب الزعيم النهضوي قوبل آنذاك بمثابة صنيعة على أنه مثال في الصدق بما تضمنه من انسجام في الخطاب الإسلامي ومن حرص مشترك على أسلمة الدولة والمجتمع، ولو كان المتقبل غير راضٍ عن المنظومة بأكملها (فقبول التعرف على التواطؤ لا ينفي رفضه والسكوت عنه إلى حين). وبالتالي يتمثل تبديل معنى الفيديو اليوم في تبدّل الموقف الأمريكي من حزب النهضة ومن رموزها. وأصبح المعنى يتضمن هذه المرة تذكيرٌ مغشوش بصدق زعيم حركة النهضة وذلك ابتغاء اصطياد عصفورين بحجر واحد: من جهة تبرئةٌ لذمة النهضويين إزاء السلفيين ومغازلة هؤلاء لأولئك من جديد في ظرف ينذر بالقطيعة بين الطيفين الإسلاميين، ومن جهة أخرى ترسيخٌ غريب لرأي راسخٍ بعدُ لدى خصوم النهضة ولدى الرأي العام، وهو الرأي القائل بسلفية حزب حركة النهضة وتواطئها مع رموز وقيادات السلفية الجهادية، بل وبحرصها المشترك مع السلفيين على تطبيق الشريعة، من بين أشياء أخرى. فهل حدث ارتداد في هذا الرأي حتى يأتي من يعيد ترسيخه؟ سيما أنّ راشد الغنوشي بنفسه اعترف بالنهاية بصحة مضمون الشريط المسرب ( تصريحه في نشرة الأنباء في ليلة 11-10-2012 وفي برنامج خاص أعدّ ليلتها بالمناسبة). إنّ الخطر يكمن مبدئيا في طبيعة هذا المنهج التسريبي والمرسِّخ لحقيقة معلومة، وهو بصفته هذه منهجٌ مكيّفٌ لإرادة الشعب ومنافٍ لمبادئ الثورة ولنمط المجتمع التقدمي، ولكنه موالٍ لإرادة حزب حركة النهضة ولنمط الدولة الدينية.
ومن هنا نأتي إلى الخطر الأكبر. من أين لحزب النهضة اللجوء إلى مثل هذا المنهج في التعامل مع المعلومة وبواسطتها؟ ومن قد يكون وراء الرغبة في ترسيخ حقيقة معلومة ضمنيا حتى تصبح ذائعة بكل مباشراتية؟ فحزب "النهضة" الذي لم يكن قادرا على امتداد الأشهر العشرة التي قضاها في الحكم على تركيع الأهالي في عديد الجهات لمّا أراد فرض المعتمدين والولاة عليهم، من أين له أن يستنبط منهجا للتسريب جديرا بالـ"ويكيليكس"؟ اللهم إذا كان الذي فعل الفعلة طرفٌ يعتبر نفسه ضالعا في مجريات الأحداث و معنيا بالنتائج التي قد تفرزها هذه الأحداث، بما فيها حدث التسريب نفسه، مما لا يستبعد الفرضية القائلة بضلوع الطرف الأمريكي، وهو المعني وبدرجة عالية، بالمجريات الأخيرة بالنظر إلى واقعة السفارة. وفي صورة عدم صحة هذه الفرضية، قد تصح فرضية استلهام "النهضة" للمنهج من عند الأمريكان وبالتالي تتأكد فرضية تعمد هذا الحزب تسريب الشريط مؤخرا. أليس المنهج حمّالا لروح الفلسفة والسلوك الأمريكيين المسمى بالـ"البراغماتية" (الذرائعية)، وأليست "النهضة" شريكا للولايات المتحدة بما يلوّح بالتشارك معها حتى في المناهج وأساليب العمل والتحرك السياسي، بما فيها الذرائعية؟
بكل المقاييس، وبصرف النظر عن صحة مضمون الفيديو من عدمه، من الأرجح أن يكون توقيت التسريب هو التجسيد الوقح للخطر الأكبر. وبالتالي نحن أمام فتيلة موقوتة تكمن خطورتها في ممارسة البراغماتية على الشعب التونسي، مجتمعيا وإعلاميا، وبأيادٍ سياسية أهلية. وهو المنهج الخطير الذي طالما احترزنا على استهلاكه بصفة اعتباطية ولاواعية في مجتمعنا (مقالنا "الصراع بين الشريعة والذريعة"، منشور على المواقع الالكترونية). فالمنهج التسريبي ذرائعيّ بامتياز إذ إنه يهدف لا فقط إلى تطبيع التونسيين مع الشريعة كوسيلة للاستبداد بالمجتمع، ومع مَن يريد تطبيقها، ومع مَن يرغب في ممارسة الاستبداد بالشعب، وإنما أيضا، وهو الأدهى والأمرّ، إلى تطبيعهم مع وسيلة خبيثة تزيّنُ لهم الاستبداد "الشرائعي" شريطة أن لا يمسّ هذا الأخير مصالحَ الدولة الأعظم بأيّ سوء.
محمد الحمّار
ألم نعُد نفهم النص إلا بشرح النص؟
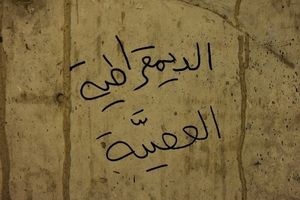 ألم نعُد نفهم النص إلا بشرح النص؟
ألم نعُد نفهم النص إلا بشرح النص؟
هممتُ بكتابة ثم نشر نصٍّ قصير، متعمدا تجربة خطاب لاهوتي أعتقد أنه بات من الضروري إقحامُه في الخطاب العام وذلك لمقاومة السلفية بكل تلويناتها، على أرضها ولِمَ لا أمام جمهورها، وإيجاد البديل التقدمي عنها. وقد توقعتُ أنّ المقال سوف لن ينال إعجاب القراء الكرام (ناهيك جريدة "******" المعروفة باشمئزازها من الخطاب اللاهوتي). وكان الأمر كذلك. فلا المقال حصل على عدد كافٍ من "الايك" على المواقع الاجتماعية، ولا الجريدة نشرَته. وفي ما يلي النص كاملا:
"إن الحركات الإسلامية السياسية طُبعت بجهل مجتمعاتها وحتى الإسلام لم ينجُ من تركيب صفة الجهالة عليه. لذا فكل تغيير نحو الأفضل يبدأ بتغيير نظرتكم إلى الإسلام أي بتطهيره من الجهل الذي ألصق به. وهل من طريق إلى الطهارة أفضل من مزاوجة الإسلام مع العلم نظريا وعمليا.
إنّ فشل المرحلة الانتقالية الأولى التي بدأت بعد انتخابات 23 أكتوبر وستنتهي في يوم 23 أكتوبر الجاري تعزى إلى ابتعاد تونس، شعبا ومجتمعا وأحزابا وسلطة وأفرادا، عن الإسلام المصدري وعن روح الحركة المحمدية وعن الوحي الذي تنبض من خلاله قلوب الناس جميعا. فالإسلام ليس فوضويا بينما تونس تعيش الآن في فوضى سينمائية. والإسلام مرشدٌ إلى النظام بينما لم يبق لتونس من نظام سوى ذلك الاسم الذي تحمله الفرقة البوليسية المختصة في القمع: "النظام العام". فمتى سنخلد للعلم لإيجاد النظام؟"
وفي ما يلي شرحٌ للفقرة الثانية للنص (وهي التي أردناها أن تكون صادمة):
"يمكن أن نفسر فشل المرحلة الانتقالية الأولى في تونس بافتقار المجتمع إلى رسالة واضحة المعالم تكون مرآة عاكسة لمطالب الشعب المشروعة مثل الحرية والكرامة، وهي نفس الصورة الأزلية التي رسخها الإسلام في المؤمنين وحث على العمل من أجل تجسيدها. أما السبيل إلى الاهتداء إلى طريقة العمل المفضية إلى النظام فهي لا شيء غير العلم."
في الختام لم يبق لنا إلا أن نتساءل: هل اللجوء إلى شرح النص مرحلة ضرورية لتشكل خطاب ديني إنساني ومن ثمة لإدماج هذا الأخير شيئا فشيئا في الخطاب العام ابتغاء توحيده وتحقيق الوفاق اللغوي، أم الأجدى أن تبقى العلاقة الصدامية والتجاذبية بين الخطابات هي السائدة؟
محمد الحمّار
هل قدر تونس إما الفوضى أم النظام العام؟
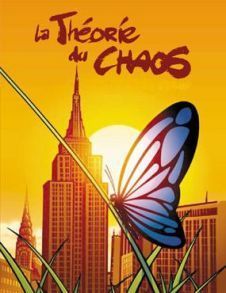 هل قدر تونس إما الفوضى أم النظام العام؟
هل قدر تونس إما الفوضى أم النظام العام؟
إن الحركات الإسلامية السياسية طُبعت بجهل مجتمعاتها وحتى الإسلام لم ينجُ من تركيب صفة الجهالة عليه. لذا فكل تغيير نحو الأفضل يبدأ بتغيير نظرتكم إلى الإسلام أي بتطهيره من الجهل الذي ألصق به. وهل من طريق إلى الطهارة أفضل من مزاوجة الإسلام مع العلم نظريا وعمليا.
إنّ فشل المرحلة الانتقالية الأولى التي بدأت بعد انتخابات 23 أكتوبر وستنتهي في يوم 23 أكتوبر الجاري تعزى إلى ابتعاد تونس، شعبا ومجتمعا وأحزابا وسلطة وأفرادا، عن الإسلام المصدري وعن روح الحركة المحمدية وعن الوحي الذي تنبض من خلاله قلوب الناس جميعا. فالإسلام ليس فوضويا بينما تونس تعيش الآن في فوضى سينمائية. والإسلام مرشدٌ إلى النظام بينما لم يبق لتونس من نظام سوى ذلك الاسم الذي تحمله الفرقة البوليسية المختصة في القمع: "النظام العام". فمتى سنخلد للعلم لإيجاد النظام؟
محمد الحمّار
ما هو البديل عن السلفية؟
باقتراب موعد 23 أكتوبر المثير للجدل تزداد المؤشرات تأكيدا على فشل حكومة الترويكا في عملها بقيادة الحزب ذي المرجعية الدينية، أكثر من تأكيدها على إمكانية التدارك. فبالرغم من أنّ هذه الحكومة ائتلافية، إلا أنّ غلبة اللون الديني عليها، كسابقة في التاريخ السياسي للبلاد، يُعدّ في رأينا العامل الأساس المسؤول عن اهتزاز الأرضية السياسية العامة بالبلاد وعن ارتجاج العقل السياسي فيها. والأدهى والأمر من فشل الحكومة أن تصبح طلبات الشعب الثورية من حرية وكرامة وغيرها خالية من الدلالة الحقيقية وذلك بالرغم من أنها بديعة ومشروعة. وهي كذلك لا لأنها بالية ومتكررة، ولا لأنها مستحيلة التحقيق أو مجحفة أو تعجيزية، بل لأنّ منهاج تحقيقها حاضر بغيابه. فالمجتمع يفتقر إلى الوسائل المنهجية السانحة للنضال من أجل تحقيق أهداف نبيلة إلى درجة أنّ ذلك الفقر صار ينزل بكل ثقله على الطلبات نفسها، مما يُشوّش على العقول ويشكك حتى في الأهداف. لماذا كل هذا الارتباك في الاهتداء إلى المنهاج الثوري القويم؟ نفترض ببساطة أنّ السبب يكمن في أنه قد تم "الركوب" على الثورة، ولو أنّ "الركوب" لم يكن متجسدا في الابتعاد تماما عن الأرضية الثورية، وإنما يتجسّد في كوننا لم نعُد متشبثين بهذه الأرضية بواسطة القدمين الاثنتين، أو ربما لم نطأ هذه الأرضية أبدا بالاثنتين معا، كما سنرى. فما هو العامل الرئيس المتسبب في حدوث مثل هذه الزلة الخطيرة؟ وما هو البديل المنهجي الذي من شأنه أن يسهم في تخطي عقبة 23 أكتوبر وفي التقدم بالبلاد إلى المرحلة الانتقالية الموالية بنجاح؟
يأتينا الجواب من مجابهة مقولة نعتبرها مثيرة للجدل ألا وهي "فصل الدين عن السياسة" ومن تفرعاتها على غرار " التصدي لكل أشكال التوظيف السياسي للدين ". فمطلب الفصل مثير للجدل لأنه صائب بقدر ما هو مخطئ. وفي بطانة هذه المفارقة يكمن اللغز بخصوص الزيغ المنهجي. إنّ البيان صائب إذا اعتبرنا أنه قد تم فعلا توظيف الدين في السياسة، أولا بالترخيص لحزب النهضة الديني، ومن بعده حزب التحرير وأحزاب سلفية أخرى، في النشاط العلني. وجل الناس يعلمون أنّ فوز حزب النهضة بالأغلبية النسبية في انتخابات 23 أكتوبر يعود بالخصوص إلى كونه حزبا دينيا. كما أنّ الدين يتم توظيفه بين الحين والآخر من قِبل أطراف خفية وأخرى مكشوفة إلا أنها فاعلة سلبا في المجتمع بحُكم خطابها المبسّط بدعوى بساطة الدين الحنيف. وهذه الأطراف تلجأ إلى أنماط خطيرة من توظيف الدين في السياسة رغم أنّ الأنماط تختلف عن بعضها البعض في درجة الخطورة. وتكمن خطورة التوظيف في كونه يكرس الانقسام والفرز في داخل المجتمع السياسي، ويتسبب في حيرة المجتمع ككل.
والمطلب مخطئ لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار أنّ توظيف الدين في السياسة قد تم فعلا وهو من المحصول الحاصل، لذا فالأجدى بالعقل المجتمعي أن يسايره لا أن يقصي العمل به. فالإقصاء هو الذي كان من قبل قد تسبب في تنامي ظاهرة الإسلام السياسي وكذلك السلفية بأصنافها. فالأحرى بالنخب المثقفة أن تفكر في مكانة الدين الطبيعية وفي دوره الطبيعي إذا اعتبرنا مشروعية رفض أن يُمزج الدين بالسياسة. وهذا يتطلب استبدال "مقاومة" الفكر السلفي "على أرضيته" بدل إقصائه طِبق مبررات غير علمية مثلما حصل إلى حدّ الآن (اقتبسنا العبارات المكتوبة بين معقفين من عند الأستاذ محمد الطالبي والواردة في مقاله الممتاز "الشريعة هي المشكل والحل في إلغائها"، نشر بـ"المغرب" بتاريخ 7-10-2012، ص5). و أول سؤال يتبادر للذهن من هذا المنظور هو: هل الدين صار مسألة شخصية إلى درجة أنّ حتى الثورة لا تقبل التعبير عن الآثار الطيبة للإيمان، ولو كانت تلك الآثار تُسجَّل بالضرورة في المجال السياسي؟
إنّ إيجاد أجوبة ضافية عن هذا السؤال تستوجب الاعتراف بوجود خلل في كيفية التعامل مع المسألة الدينية. ويتجلى الخلل إجمالا في عدم استطاعة العقل المجتمعي توظيف الدين كعامل توحيد، وبالتالي عدم استطاعته أن يحُول دون أن يُستغَلّ الدين للتفريق بين مختلف الحساسيات والأطياف المذهبية والسياسية. وبالرغم من أنّ الحركات الإسلامية قد فازت في الانتخابات إلا أنها فشلت (مَثلها مَثل الأحزاب العلمانية) في تعبئة شرائح المجتمع العربي المسلم بنفس الكثافة والإجماع والقيمة التي يقدر الإسلام وحده على تعبئتها. كما أنّ كل الأحزاب والحركات باتت فاشلة في تصوّر بناءٍ لمجتمع ملتزم لكنه عصري أي فاعل في التاريخ. وفي ضوء هاتين المعاينتين قد يكون الوقت حان للتذكير بأنّ حياة المسلم تكون ناجحة لمّا يستلهم المسلم دوافع التفكير والعمل والسلوك من تجربة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن يستنسخها منه عليه السلام. إنه قدوة المسلمين ومرجعيتهم المسندة بالقرآن الكريم، لا نموذجا للاستنساخ. بهذه الطريقة تكون حياة المسلم امتدادًا للإسلام المصدري ولحياة السلف وتجديدا له، أي عودةً إلى الينابيع الإسلامية لكن بنظرة جديدة و بأساليب حديثة. وهذا يتطلب اتخاذ موقف تاريخي يتلخص في ما يلي: الإسلام وراءنا إذا اعتبرنا تجربة الرسول الكريم التجسيد الوحيد الذي يجدر تسميته بالحقيقي للدين الحنيف؛ والإسلام أمامنا إذا اعتبرنا المستقبل تطبيقا له، نتوق إليه ونضطلع بتحقيقه؛ وسيتبين أنّ الإسلام فينا ومعنا آنيا إذا كنا قادرين على التمركز التاريخي على تلك الشاكلة.
للأسف لمّا حدثت ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي لم نكن، كمجتمع مسلم، متمركزين هكذا. ثم عُقدت انتخابات دون أن يُسجَّل أيّ توجه نحو الموقف التاريخي الضروري. هكذا تكون الثورة قد مكنتنا من وضع قدم واحدة في مسار التاريخ بينما بقيت القدم الثانية عالقة في الفضاء. وستبقى في هذا الوضع، وضع الزلة، ما لم نتصالح مع التاريخ. والمصالحة تتطلب الاعتراف بالعامل الديني كمعطى تاريخي أي داخلٍ في الثورة لا خارجٍ عنها. لكن هذا الشرط يرتطم بعقلية راسخة بفضل إجماع (خطير) مفاده أنّ الإسلام لم يكن له دخلٌ قطّ في الثورة. وهذه المغالطة الذاتية تتأكد من خلال معاينة الإقرار بأنّ "الثورة قد حصلت بغير شعارات، لا دينية ولا اشتراكية ولا قومية ولا غيرها ". ومن هنا نأتي إلى واجهة أخرى كانت تفتقر إلى التأصيل التاريخي، ألا وهي الاستحقاق الانتخابي. وهي الواجهة التي نرى فيها المجتمع (الضيق؛ النخبوي؛ العلماني المتطرف؛ المنقوص من الأغلبية الصامتة) يضع ثقته التامة في صندوق الاقتراع، الذي سيسفر حسب ظنه، عن نتائج تعكس تاريخ البلاد وانفتاح أهلها واعتدال تديّنها. لكن يبدو أنّ المغالطة الذاتية انطلت على العلمانيين المتطرفين ولم تنطلِ على إسلاميي حزب النهضة، مما حدا بهذا الحزب أن يستغل الفرصة. فكان مجرد الإقرار بأنها ثورة خالية من الشعارات فرصة سانحة له كي يستأثر برأي الأغلبية ممن صوتوا فعليا (وهي أغلبية نسبية). وبالمحصلة أخذ الحزب الديني لا فقط نصيبه من الإسلام، إن صح التعبير، وإنما أيضا نصيب غيره المتخلي (الأغلبية الصامتة). وهنا تكمن المشكلة. إذ إنّ التمتع بنصيبٍ شرعي وبنصيب فائضٍ في الآن ذاته يخلق الوصاية على الآخر الذي افتُكّ منه نصيبُه. وهو ما سمي إعلاميا بـ"ركوب الإسلاميين على الثورة".
وقوفا عند هذا المستوى، نستنتج ما يلي:
أ. أنّ "الأغلبية الصامتة" التي لم تشارك في الانتخابات تمثل شريحة حكيمة بقدر ما هي غير مسؤولة ومتخاذلة. إذ إنها من جهة توجست خيفة من الانسياق إلى أحد القطبين، الإسلامي والعلماني المتطرف، ومن جهة أخرى فرطت في "نصيبها من الإسلام" لفائدة حزب حركة النهضة (وللسلفيين الذين سيظهرون فيما بعد). أي أنها كانت من الأول قابلة لقوانين الوصاية التي ستمارس عليها.
ب. أنّ مجتمع النخبة (العلمانية واليسارية) كان يبحث عن الحلول السهلة. ومن بين هذه الحلول لجوءه إلى صندوق الاقتراع على أمل أن يكون هذا الأخير هو الفيصل في إقصاء الإسلاميين بما معناه أنّ الصندوق سيثبت أنّ الإسلام السياسي ليس له مكان في مجتمع مسلم. بينما النتيجة كانت معاكسة تماما لِما يتمناه مجتمع النخبة، وكان الفوز للإسلاميين.
ج. إن فوز حزب حركة النهضة الإسلامي في مرحلة أولى ثم نكوصه شيئا فشيئا إلى الوراء في مرحلة ثانية (الآن) دليل على أنّ صندوق الاقتراع ، لئن هو الفيصل مبدئيا في السماح بالإدلاء بالأصوات في كل عملية انتخابية ديمقراطية، فليس هو الفيصل (ولم يكن هو الفيصل) في تحديد طبيعة المشكلات المتعلقة بالمسألة الدينية في مجتمع متحِد تاريخيا حول الإسلام. بكلام آخر، لقد أجريَ الاستحقاق الانتخابي كأول تجربة ديمقراطية في البلاد والحال أنّ المشكلات المؤثرة في التوجهات الكبرى (وفي الأحزاب وفي البرامج السياسية وفي اختيارات الناخبين)، ومن أهمّها تلك المتعلقة بالدين وبمكانته، بقيت عالقة. وإذا بقيت عالقة يبقى الوفاق السياسي غائبا والفرز الإيديولوجي سائدا، مثلما هو الحال الآن.
من هنا نتخلص إلى الإقرار بأنّ "ركوب" الإسلام السياسي على الثورة (في تونس وفي مصر وفي ليبيا وأينما وقعت وستقع الثورة) برهان على ضرورة ضم الدين إلى المسار التاريخي للثورة. ذلك أنّه كان "ركوبا" اضطراريا في انتظار أن يصير تأصيلا اختياريا. وهو كالسراب يحسبه الظمآن ماءً، لأنّ رموزه يبثون خطابا فُصاميا، لكأنّهم يقولون للمسلم: "أنت لم تكن مسلما أبدا، ولست مسلما الآن، لكن ستكون مسلما طالما أنك تأتمر بأوامر أناس طيبين مثلنا". وهذه هي الوضعية التي نرى فيها قدَما واحدة، دون الثانية، راسخة في الأرض. بينما يكون التصحيح التاريخي بالقول: "كنتَ مسلما، وأنت الآن مسلم طبعا، لذا كن مستقبلا أفضل مما كنت ومما أنت الآن". ولكي يتم تصحيح الثورة وتثبت القدمين الاثنتين على اليابسة لا بدّ على العقل المجتمعي أن يستبطن الحقيقة التالية: كنا مسلمين قبل الثورة فليس هنالك داعيا لا للركوب عليها باسم الإسلام (كما حدث اضطراريا) ولا للتنصل من الإسلام، إما على خلفية الخشية من أن يركب عليها فرقاء سياسيون باسم الدين وإما، في الصورة المعاكسة، بواسطة الإقصاء المتعمد للدين بدعوى الطبيعة العلمانية للثورة. إذا تخطينا هذه العقبة، عقبة التمركز التاريخي، ستأتي تدريجيا الأجوبة المتعلقة بالسؤال المحوري "هل يُمزج الدين بالسياسة أم يُفصل؟" وسيكون ذلك من دون هوَس، نظرا لأنّ السؤال بحد ذاته مؤشر على علل بليغة كامنة في المجتمع تتعلق بالموقف التاريخي الخاطئ، أكثر من كونه معبّرا عن العلة نفسها. فتصحيح مشكلة الموقف التاريخي ستكون نقضا لذلك السؤال من أساسه.
كما نتخلص إلى التشديد على أنّ التجربة الإسلامية (الحضارية والثقافية والإيمانية)، التي هي سابقة للثورة، لم يبق سوى أن تُستقرأ كقانون أنسني وناموس تاريخي لشعب تونس بل للأمة العربية الإسلامية، لا أن تُستبعد كما يريد العلمانيون المتطرفون، ولا أن تُستبدل بأخرى ابتداءً من نقطة الصفر الواهية، كما يريد الإسلاميون. إنّ النقطة الصفر الأصح هي تلك التي تطلق العنان للمخيال السياسي كي يبحث عن البديل عن السلفية. وهي النقطة التي يتلاقى عندها الماضي والحاضر والمستقبل في الوعي في الآن ذاته.
بالنهاية لئن لا يعني الإقرار بتاريخية الإسلام الابتعاد عن إنجازات السلف (وهي التي وراءنا)، ولا عن مقاصد الإسلام (وهي التي أمامنا) ولا عن مضمونه (الذي هو في كل زمان ومكان)، فتبقى الطريق إلى التحرر التام طويلة وشاقة لأنّ بعد تصحيح الموقف التاريخي واستشراف الإستراتيجية الإرشادية الحديثة سيأتي حتما دور تفصيل المنهاج وتصريف الخطاب وتحرير الرسالة المعاصرة للمسلمين. للتلخيص، هل يُمزج الدين بالساسة أم يُفصل عنها؟ أعتقد أنه لا ينبغي أن نبقى عالقين بإجابة جاهزة عن هذا السؤال لأنّ طرح السؤال يدل على عدم استعداد المجتمع لاستبطان فكرة التنوير، ناهيك أن يعي بأنّ العمل المطلوب إنجازه يهدف إلى محو كافة المشكلات المغلوطة وما يتعلق بها من حلول ظرفية لا تصلح إلا كمسكنات. فهل النخبة التربوية جاهزة لأداء دورها الإرشادي وهل المجتمع مستعد لاسترشاد؟
محمد الحمّار





